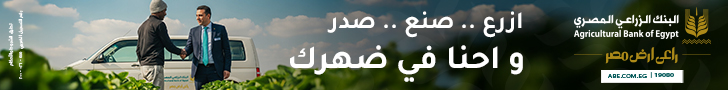بقلم: الكاتب الصحفى أحمد شلبى
في لحظة تبدو معلّقة بين زمنين، يقف القارئ أمام مسرحية “أهل الكهف” لتوفيق الحكيم؛ العمل الذي لم يكن مجرد إعادة صياغة فنية لقصة دينية، بل تجربة فكرية عميقة تهزّ يقين الإنسان بثبات الزمن وتعيد ترتيب أولوياته الوجودية.
لقد منح الحكيم الأدب العربي واحدة من أكثر لحظاته إشراقًا حين صاغ نصًا يجعلنا نرى الزمن لا كعقرب ساعة يدور، بل كقوة قادرة على سحق الإنسان أو تحريره، على بعثه أو دفنه وهو حي.
الحكيم… الفيلسوف الذى كتب بالمسرح
لم يكن توفيق الحكيم مسرحيًا تقليديًا؛ بل مفكرًا يرتدي قناع الدراما.
أدرك مبكرًا أن المسرح ليس منصة للعرض فقط، بل مساحة لتوليد الأسئلة الكبرى:
هل يملك الإنسان مصيره؟ هل يُهزم الزمن أم نحن الهزيمة ذاتها؟
وهي الأسئلة ذاتها التي بنى عليها “أهل الكهف”، فأصبحت المسرحية علامة فارقة في ما سمّاه النقاد «المسرح الذهني»؛ ذلك الفن الذى يشتعل داخل العقل قبل أن يضيء خشبة المسرح.
أبطال يعودون من نومٍ طويل… ليجدوا أن العالم لم يعد لهم
يستيقظ الفتية الثلاثة مرنوش، يمليخا، مشلينيا بعد ثلاثة قرون من النوم، فيصطدمون بعالم لا يعرفونه، ولغة غريبة عليهم، وأهل فقدوا أسماءهم في الذاكرة.
لكن المأساة الحقيقية ليست في ضياع المكان؛ بل في ضياع الزمن.
فالإنسان يستطيع أن يغيّر مدينته، دياره، وحتى أمجاده، لكنه لا يستطيع أن يعيش خارج زمنه.
وهنا يضع الحكيم القارئ أمام مفارقة وجودية حادة:
هل يمكن للإنسان أن يعود إلى حياة توقفت منذ ثلاثمئة عام؟
أم أن الزمن حين يمضي لا يعود، ولو عاد الجسد؟
حبّ لم يعد موجودًا… ووطن غادر أهله
أشد مشاهد المسرحية ألمًا هو عجز مشلينيا عن استعادة حبه القديم “بريسكا”.
فالحب الذي ظنّه خالدًا، أصبح مجرد أثر، وصاحبه لم يعد موجودًا إلا في ذاكرة ضبابية.
هنا يقدّم الحكيم فلسفته الأعمق:
أن الإنسان لا يعيش بالتاريخ، بل بالحاضر؛ وأن الذكريات مهما خلّدت، تذبل إن لم تجد من يشاركها الزمن نفسه.
توفيق الحكيم… ورؤية مسبقة لقلق الإنسان المعاصر
حين كتب الحكيم “أهل الكهف” عام 1933، لم يكن العالم قد عرف بعد حوادث الانفجارات الوجودية الكبرى التي ستجتاح القرن العشرين.
ومع ذلك، جاء نصّه وكأنه يستشرف أزمات اليوم:
الاغتراب، الانفصال عن الواقع، فقدان المعنى، ومحاولة الإنسان البحث عن “زمنه الضائع” وسط عالم يتغير بسرعة مرهقة.
لماذا تبقى “أهل الكهف” حية حتى الآن؟
لأنها ليست مجرد مسرحية، بل تجربة تأملية في جوهر الإنسان.
كل قارئ يجد نفسه فيها:
من فقد زمنًا، أو حنينًا، أو إنسانًا،
من حاول العودة إلى ما كان، فوجد أن الحياة لا تلتفت خلفها.
لقد اختار الحكيم أن يختتم مسرحيته بموت الفتية، لا عجزًا دراميًا، بل لأن العودة المستحيلة إلى الزمن القديم كانت موتًا معنويًا منذ البداية.
كلمة أخيرة
إن توفيق الحكيم لم يكتب نصًا فحسب؛ لقد كتب مرآة يرى فيها كل جيل نفسه.
وإذا كان الزمن قد تغيّر، فإن أسئلة “أهل الكهف” ما زالت كما هي:
كيف نعيش زمننا؟
وكيف نتصالح مع فكرة أن الماضي لا يعود حتى لو عدنا نحن إليه؟
 معاق برس حقوق لا عطايا
معاق برس حقوق لا عطايا