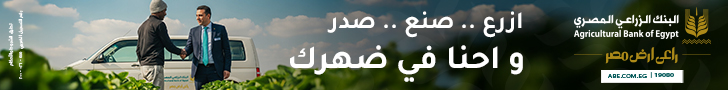كتب/ أحمد شلبى
وقائع موثقة من زمن لم يكن الفرح فيه موضع اتهام
منذ أربعينات القرن العشرين وحتى نهاية السبعينات، شكّل الاحتفال برأس السنة الميلادية جزءًا طبيعيًا من المشهد الثقافي والفني في مصر وعدد من العواصم العربية. لم تكن المناسبة محمّلة بدلالات دينية أو أيديولوجية، بل عُدّت حدثًا اجتماعيًا وفنيًا، وواحدة من مواسم النشاط الثقافي البارزة.
الصحافة المصرية آنذاك توثّق هذا بوضوح. فمجلات مثل روز اليوسف والكواكب وصباح الخير كانت تنشر سنويًا صور الفنانين في سهرات رأس السنة، وتخصص صفحات لتهاني النجوم وتوقعاتهم للعام الجديد، دون أي حساسية اجتماعية أو دينية.
أم كلثوم، على سبيل المثال، أحيت عددًا من حفلات رأس السنة المذاعة، من بينها حفل موثق في 31 ديسمبر 1944، أُعلن عنه في الصحف بوصفه “سهرة رأس السنة”. محمد عبد الوهاب شارك بدوره في سهرات إذاعية مشابهة، وقد أشار في حوارات صحفية إلى أن نهاية العام كانت “موسمًا فنيًا” بامتياز.
في الفنادق الكبرى مثل شبرد وسان ستيفانو، كان فنانون مثل فريد الأطرش يحيون سهرات خاصة يحضرها صحفيون وكتاب ومثقفون. أما المسارح، وعلى رأسها مسرح رمسيس ليوسف وهبي، فكانت تقدم عروضًا احتفالية في هذه المناسبة، غالبًا ذات طابع اجتماعي أو كوميدي.
حتى الكازينوهات والمسارح الاستعراضية، التي شاركت فيها فنانات مثل تحية كاريوكا وسامية جمال، كانت جزءًا معلنًا من هذا المشهد، دون أن يُنظر إلى نشاطها باعتباره خروجًا عن القيم العامة. وتؤكد مذكرات تحية كاريوكا، وعدد من الدراسات عن المسرح الاستعراضي، أن تلك العروض كانت تُعد تعبيرًا عن الحداثة الفنية لا عن الانفلات الأخلاقي.
الأدباء بدورهم لم يكونوا بعيدين عن هذا السياق. نجيب محفوظ، في حواراته مع نقاد مثل رجاء النقاش، أشار إلى جلسات رأس السنة التي كانت تجمع الأدباء والفنانين في مقاهٍ أو بيوت خاصة، باعتبارها سهرات ثقافية وحوارية لا أكثر.
اللافت أن هذه الممارسات كانت تجري في العلن، وتحت عين الدولة والصحافة، ما يعكس قبولًا اجتماعيًا واسعًا لفكرة الاحتفال بوصفه فعلًا إنسانيًا وثقافيًا، لا موضعًا للجدل أو التحريم.
من موسم فرح إلى مساحة اشتباه
كيف انعكس صعود الخطاب المتشدد على الفن والذوق العام؟
مع أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، بدأ المشهد الثقافي والفني يشهد تحوّلًا تدريجيًا، تزامن مع صعود التيارات الدينية المسيسة، واتساع حضور الخطاب الوعظي في المجال العام. هذا التحول لم يكن مفاجئًا، لكنه ترك أثرًا عميقًا على طبيعة الفن والذوق السائد.
قبل هذا التحول، كان الفن يقود الذوق العام ويعيد تعريفه. الموسيقى تنوّعت بين الطرب والتجريب، والسينما ناقشت الحب والرغبة والأسئلة الوجودية بلا خوف من الوصم الأخلاقي. أما بعد ذلك، فقد بدأ الفن يخضع لما يمكن تسميته “الرقابة الاجتماعية”، حيث صار المبدع يحسب ردود الفعل الدينية والأخلاقية قبل حساب القيمة الفنية.
في الموسيقى، تراجعت الجرأة العاطفية لصالح أغانٍ محايدة أو وعظية، وظهر لأول مرة مصطلح “الفن النظيف”، وهو توصيف لم يكن متداولًا في العقود السابقة. في السينما، انتشرت أنماط سردية تنتهي غالبًا بالتوبة أو العقاب الأخلاقي، وتقلّصت صورة المرأة بوصفها كائنًا مستقلًا، لتحل محلها ثنائية الضحية أو النموذج المثالي المنزّه.
المسرح بدوره تراجع من مساحة للتجريب والنقد الاجتماعي، إلى عروض كوميدية خفيفة تخلو في الغالب من الأسئلة الكبرى، تجنبًا للصدام. أما الذوق العام، فقد بدأ ينظر إلى الفرح نفسه بشيء من الريبة، واختُزلت القيم الجمالية في مفردات مثل “الستر” و“الرسالة” و“المقبول”.
الخلاصة أن ما جرى لم يكن تحولًا دينيًا بقدر ما كان إعادة توظيف للدين في المجال العام، بما فرضه من قيود غير مكتوبة على الإبداع. ففي الزمن السابق، كان الاحتفال بالحياة فعلًا طبيعيًا، أما لاحقًا، فقد وجد الفن نفسه في موقع الدفاع عن شرعيته، بدلًا من أن يكون طليعة للتغيير والذوق.
 معاق برس حقوق لا عطايا
معاق برس حقوق لا عطايا